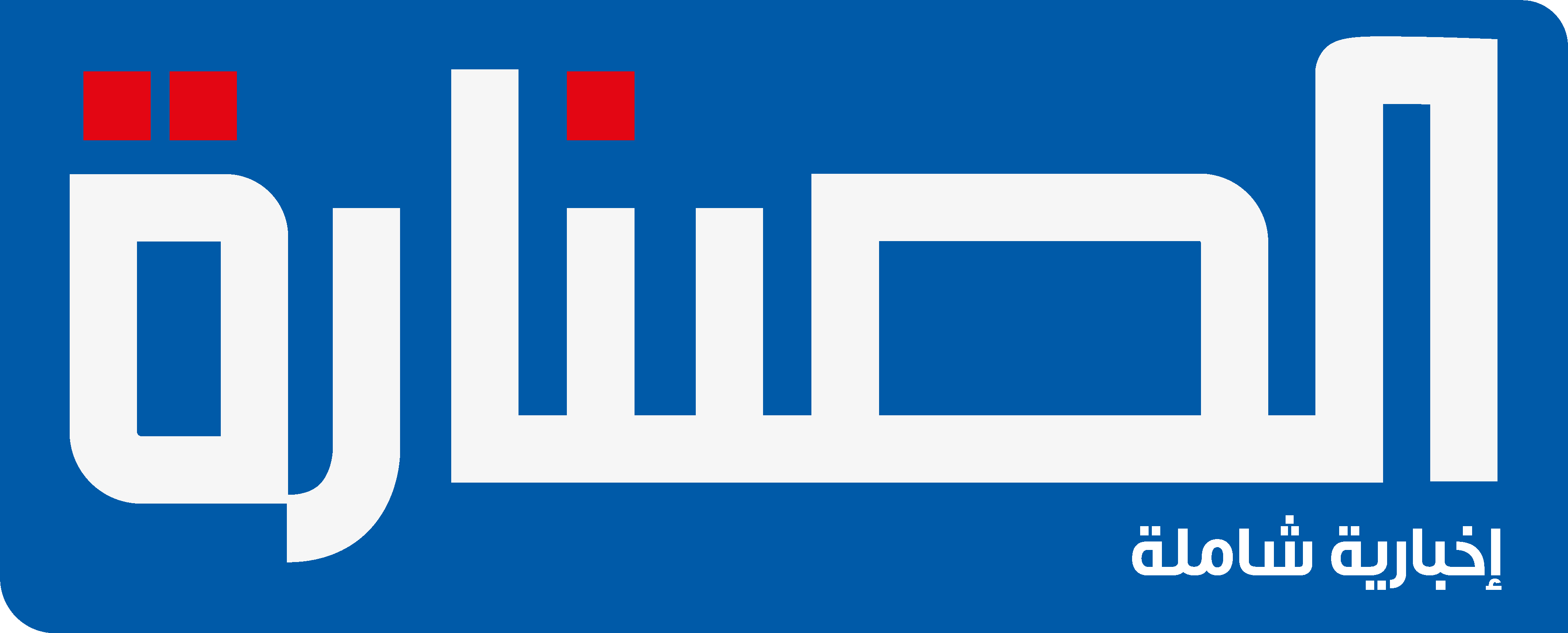غزة : عائلات تدفن أبناءها دون يقين من هويتهم
صنارة نيوز - 08/02/2026 - 6:17 pm
في غزة، لم يعد الموت نهاية القصة، بل إن القصة الحقيقية تبدأ بعده، حين تقف أمّ أمام صورة جثمانٍ بلا ملامح، وتحاول أن تقنع قلبها بأن هذا الركام هو ابنها.. تبدأ حين يُسأل الأب عن علامةٍ فارقة في جسدٍ متحلل، وحين تُطلب من العائلة شجاعة الاعتراف بما لا يمكن احتماله: “نعم، هذا هو، أو ربما لا”.
سُلب الفلسطيني حق الحياة، في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ثم سُلب حق الوداع، ثم سُلب حتى حق اليقين هنا، تُدفن الجثامين قبل أن تُدفن الأسئلة، وتبقى القلوب معلّقة بين القبر والشك.
يقول المتحدث باسم الأدلة الجنائية إن المشاهدات البصرية التي يتم عرضها من خلال الصور على أهالي المفقودين في قطاع غزة ليست أكثر من محاولات محدودة، تبذلها الجهات المختصة عبر تسخير إمكانياتها المتواضعة من مقاييس الرسم وبعض الكاميرات، واستخدام التصوير الجنائي الاحترافي على الجثامين، في محاولة لمساعدة الأهالي على التعرف على أبنائهم الشهداء.
ويؤكد أن هذه الطرق تقليدية وبدائية، ولا تسمن ولا تغني من جوع أمام حجم الكارثة، موضحًا أن نسبة التعرف على جثامين الشهداء بهذه الوسائل هي نسبة قليلة جدًا، ولا ترقى إلى مستوى الحسم.
ويشير إلى وقوع أخطاء مؤلمة خلال عمليات التعرف، حيث تتعرف عائلتان مختلفتان على الجثمان نفسه، كلتاهما تقرأ العلامات الفارقة بعين الرجاء، وتؤمن أن الجثمان يعود لابنها، عند هذه النقطة، تقف الأدلة الجنائية عاجزة عن الحسم، ولا يكون الفصل إلا عبر إجراء فحوصات الحمض النووي للجثمان ومطابقته مع عائلته، وهو غير ممكن.
ويوضح عاشور أن الاحتلال الإسرائيلي، حين يرسل الجثامين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يرفقها أحيانًا ببيانات الحمض النووي الخاصة بالجثمان، إلا أن هذه البيانات لا قيمة لها داخل قطاع غزة، في ظل عدم وجود قاعدة بيانات للحمض النووي لأهالي المفقودين.
ويصف ملف التعرف على جثامين الشهداء بأنه من أكثر الملفات قسوة وتأثيرًا نفسيًا، ليس فقط على الأهالي، بل أيضًا على الطواقم الطبية والفنية، إذ يتم توثيق الجثامين وهي في حالات تحلل متقدمة، وعليها آثار تعذيب وإصابات، وبعضها مجرد أشلاء، ما يترك أثرًا نفسيًا بالغ السوء على الجميع.
ويؤكد أن من أصعب المواقف التي تواجه الطواقم، لحظة وصول العائلة إلى قناعة بنسبة 90% أن الجثمان يعود لابنها، لكن تبقى 10% مفقودة تمنع الحسم النهائي، في تلك اللحظات، تعجز الطواقم الطبية والفنية عن تقديم أي مساعدة إضافية، ويبقى السؤال معلقًا بلا إجابة.
ويقول شاهد “بعض العائلات تدفن جثمان الشهيد، والشك يعتري قلبها… هل الذي دفنته هو ابنها أم لا؟”، مؤكدًا أن هذه الشكوك تظل ترافق الأهالي حتى بعد الدفن.
وفي بعض الحالات، تتحول عملية التعرف إلى حالة من التسابق المؤلم بين العائلات على جثمان واحد، كل منها تحاول التمسك بعلامة فارقة، قبل أن تصل الأمور إلى طريق مسدود يستحيل فيه اتخاذ القرار النهائي بين عائلتين، وسط شعور طاغٍ بالقهر والعجز لدى الأهالي والطواقم المختصة على حد سواء.
وفي السياق ذاته، قال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية قبل يومين: “تسلمنا من الاحتلال 15 جثمانا و66 صندوقًا تحتوي فقط على جماجم لشهداء، وجثث نساء لا نعلم من أين اختطفها”، مضيفًا: “الاحتلال سلّمنا جثامين مبتورة الأيدي، وأخرى فُتحت بطونها وأُعيد خياطتها”، مؤكدًا أن الاحتلال يعلم هوية جثامين الشهداء التي أعادها لكنه يرفض الإفصاح عنها.
وتشير المعلومات إلى أن الجثامين التي تم استلامها عبر الصليب الأحمر الدولي كانت مشوهة بالكامل، إضافة إلى صناديق تحتوي على أشلاء بشرية، في مشهد إنساني بالغ القسوة يفوق قدرة البشر على الاحتمال.
ويؤكد عاشور أن المواطنين غير قادرين على التعرف على جثامين أبنائهم بسبب التشوهات الشديدة، وأن بعض الجثامين الأخيرة ليست سوى أشلاء وجماجم متحللة بلا أي ملامح بشرية.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ومجلس سلام غزة بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية، والعمل العاجل على إدخال المعدات اللازمة والمختبرات العلمية المختصة بفحوصات الحمض النووي (DNA)، مؤكدًا أن هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة.
وأوضح أن ملف الجثامين مجهولة الهوية هو جزء لا يتجزأ من ملف المفقودين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم انتشال 700 جثمان من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار، من بينهم جثامين شهداء مجهولي الهوية.
وحذر من أن المأساة مرشحة للتفاقم، إذ ما يزال أكثر من 8500 جثمان مفقود ومجهول الهوية تحت الأنقاض، وفي حال انتشالهم ستكون الجثامين غالبًا متحللة وفاقدة للملامح البشرية، ما سيجعل التعرف عليها شديد الصعوبة، ويضاعف حجم الفاجعة الإنسانية.
وجدد التأكيد على أن عمليات التعرف على جثامين الشهداء في قطاع غزة تعتمد اليوم بشكل أساسي على الخبرات العلمية الشخصية للطواقم الفنية في الأدلة الجنائية وطواقم الطب الشرعي، في ظل غياب الأدوات والمختبرات العلمية، وأمام مأساة إنسانية مفتوحة لا تزال فصولها تتكشف كل يوم.