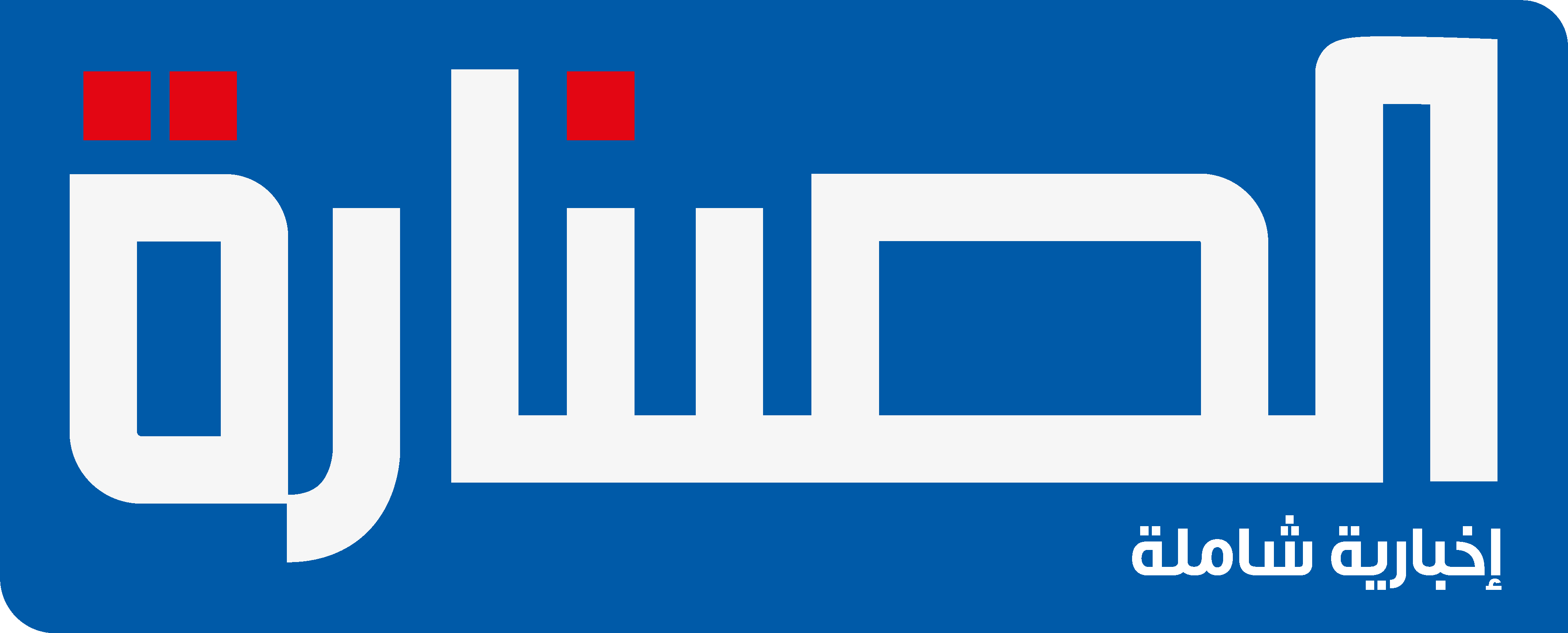استراتيجية الحبّ في رواية الضائع لـ د. سلوان إبراهيم
صنارة نيوز - 08/08/2024 - 11:56 am
قراءة: منذر اللالا
فلنبدأ بالحبّ حتّى لا ينتهي بنا الحبّ.
"إنّ هذا الحبّ في كلّ زمان ومكان، ولكنّه يشتدّ كثافة كلما اقترب من الموت"
"غابرييل غارسيا ماركيز"
"الضائع" رواية متوسطة الطول، في 259 صفحة صادرة عن دار أروقة الفكر 2024؛ للدكتورة سلوان إبراهيم؛ رواية سلسة للغاية، إذ تنساب الأفكار والأحداث والتأمّلات والحوارات انسيابا بطيئا بهيّا يشبه الحركة البطيئة في السيمفونية، لهذا لا يمكن اعتبار من يقرأ لسلوان إبراهيم كمن يشنق نفسه، رغم أنّ الحبكة والفعل الخارجي في الرواية قليلان جدّا، حيث تقع أحداث الدراما معظمها داخل الشخصيات، لا سيما شخصية "مراد"، وبالتالي فالقارئ "للضائع" لن يجد مللا أو ثقلا في اللغة أو سطحيةً في الشخصيات أو الأحداث. كأنّ سلوان تقول للقارئ: أغمض العين الحيّة، وبعدها تستطيع أن ترى بعين الروح!
تأخذ الرواية طابعاً واقعياً ورومانسياً، وتضمر أعجوبة من العواطف والأحاسيس، ويمكن أن تؤخذ كوثيقة ترصد التحوّلات النفسية، وكدراسة في التحوّلات التي تحدث في المجتمع، وهي أيضا تضمّ ثيمات متعدّدة تشكل في مجملها مقولات راسخة بقدرة الحب على الانتصار وتجاوز الحدود والسنوات وقدرته على صناعة حياة جديدة في مشوار أعمارنا.
هذا التقديم يضع المتلقّي أمام عتبات النصّ الروائي ليكون متفتحاً واضحاً لما سيقرأ، "الضائع"؛ العتبة الأولى تجعل المتلقي يسير في مسرى الضياع، ويترقّب اللحظة التي سيضيع فيها مراد عن سلمى، كما يترقّب أيضا هل سيستمر هذا الضياع أم سيجد الضائع ضالته في آخر النفق؟ بعد غربة امتدّت عشرين عاما،ً قادته الصدفة إلى منزلها في ليلة كان بها غاضبا بعد اتصال من والدته.
وموضوع ورقتي هذه هو صور الحبّ التي جمعت مراد بسلمى، وهي سيرة امتدّت حوالي ثلاثة عقود، ورغم انقطاع دام عشرين عاما، إلّا أنّ مراداً كان مسكوناً بسلمى، وكانت لا تغادره من خلال تتبع أخبارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأصدقاء المشتركين مثل زينة وأمجد.
وتعدّدت صور الحبّ في الرواية، ويمكن اختصارها بما يلي:
1-"علاقة سلمى ومراد وهي حب روحي لا تفسير له ولا مصلحة صريحة أو مادية ترجى منه":
في النص الأوّل، قادت الصدفة مراداً لبيت سلمى –فعندما تتوقّف الصدفة الباهرة عن افتداء حياتنا تكون الحياة قد جلست في الوداع الأخير. يقول الراوي:
"هل تؤمن أنّ هناك قوى قدرية تدفعك بطرق غريبة إلى مشاهد لم تكن في الحسبان؟ ليس للصدفة تعريف في قواميسه، كيف يمكن إذن أن يساق إليها بعد عقدين من الزمن؟ لم يصل إليها بإرادته، لم يبحث عنها، ورغم أنّ خيالها طاف في باله مرات عدّة خلال فراقهما، إلّا أنّه لم يحاول ولو مرّة الاتصال بها، كيف إذن وصل إلى هنا اليوم؟ وبالذات اليوم؟ “
وهنا تدخلنا الروائية مباشرة في قلب الحدث، من خلال التلميح إلى علاقة الحبّ، وإلى عقدين من الزمن غابا فيهما عن بعضهما البعض، وتمهد لنا الدخول في التفاصيل من خلال تقنية السرد الاسترجاعي، ولكن كيف كان ينظر مراد إلى الحب؟ وكيف أقنع نفسه بالتحرر من سلمى، وقد كانا سويا، ولعدّة سنوات، كأقرب ما يكون الشخص إلى نفسه، وكأجمل ما يكون عليه الحبّ الصادق؟
يحيلنا هذا التساؤل إلى ما قاله الراوي العليم عن كيفية اتخاذ مراد القرار، في صفحة 149:
"مراد شاب ذكي ومجتهد وعقلاني، مراد ليس ثوريا ولا حالما ولا شاعرا راسما للمستقبل، هو يدعي أنّه واقعي مدرك، ومن واقعيته برزت مشاكل قلبه، فلا يؤمن بالحبّ من أجل الحبّ، ولا يؤمن بترك المستقبل لزمنه، هو يؤمن بخطّة طريق مثالية يؤول فيها الخطأ إلى الصفر، ويؤمن أنّ النزوات نفسها يجب أن تكون مدروسة، وحان الآن أوان إيقاف نزوة لا مستقبل لها".
هذه كانت قناعة مراد في مراحل دراسته الجامعية وعن مدى جدية علاقته بسلمى، فهو يبرر خطوته في إنهاء العلاقة مع سلمى تحت غطاء الواقعية والعقلانية، فيتّخذ قراره ببتر علاقته بسلمى دون أدنى اعتبار لها فهو يعتبرها: "علاقة مريضة بها وبنفسه، علاقة مرهقة متعبة ملتوية، وهو يعي ما فيها من مرض والتواء، ومراد بطبعه راديكالي، يلتزم الكل أو العدم، فيبتر عضوه المصاب بدلا من الحفاظ عليه مشوها، فبتر علاقته بسلمى! "
ويبرر مراد أيضا تلك الفترة على لسان الراوي العليم: "يا لحماقة المراهقين، يمنحون كلّ ما لديهم في أول تجربة يخوضونها، يستنزفون كل المشاعر والشغف، يستهلكون كلّ الطاقة، ويقدمون قلوبهم قرابين لعلاقات مجهولة المصير، لا يرى المراهق أبعد من أنفه، يعتقد أنّ مصيره بقصة واحدة تستهلكه حتى آخر رمق، ويعتقد أنّ قلبه سيتوقّف عن النبض عند انتهاء تلك القصة." صفحة 175 – 176
وسلمى بكبريائها وشخصيتها القيادية وعزّة نفسها، لم تسأل مرادا عن المبرر ولم تطلب المخدر، ولا تأوهت من جرح ينزف! هكذا انتهت القصة إذن! لكن هل حقا تنتهي قصص الحب بمثل هذه البساطة وهل فعلا الصدفة وحدها من أعادت مراد إلى سلمى ؟!-
لم نعرف على وجه الدقة كيف كانت ردة فعل سلمى على إنهاء مراد لعلاقته بها، غير ذكر بسيط في أقل من سطرين، يقول الراوي عنها "كقطعة جليد سوحتها دموعها، تنقط جسدها بين خشبات المقعد، لا تستطيع لملمة أشلائها عديمة الشكل" صفحة 184.
للزمن علاقة وطيدة بالحبّ، سواء الزمن السردي أو زمن الأحداث، ففي لقطات الاسترجاع أو الفلاش باك جاءت ثيمة الحب بشكل متناوب بين أمس جميل وآخر صامت يقتله الفراق -وكان أطول الأزمان- وبين حاضر كل ما فيه يشي بالنضوج والحِلم والجنون وبعض زخات من الطفولة!
علاقة مراد وهبة علاقة مادية صرفة كأي زواج تقليدي مبنية على الخدمات:
هبة كانت ذكية وبذكاء متقد لتدرك الذي ينقص مراد في علاقته بسلمى، وهي كانت تتابع العلاقة بصمت ودهاء في صفحة 178 : "هبة أعطته فرصة لعلاقة كما الخيال، هو أستاذ وهي طالبة مطيعة، ليست ذكية بما يكفي لتتجاوز معلمها، وليست غبية تنفره منها، ليست قوية لتتخلى عنه، وليست ضعيفة جدا لحوحة يمل منها، جميلة بما يكفي، بريئة بما يكفي، رقيقة بما يكفي، خجولة شكورة! طموحها لا ينتمي لهندسة العمارة، لا تؤمن كثيرا بذكائها الهندسي، ولا تمانع الاعتراف بضعفها."
هبة كانت في وعي مراد عكس سلمى تماما "هبة كانت القصة التي أراد كتابتها، ليست تنينا، وليست نرجسة! هي زهيرة رقيقة تحتاج الرعاية، لن تنبت من دونه، وبمساعدته تزداد جمالا وتتألّق وبغيابه تذبل! لم تكن علاقته بهبة معقدة، لا عواصف فيها ولا براكين، لا ثورات ولا حمما ولا تانجو! علاقة هادئة بسيطة واضحة المعالم والأدوار، علاقة مريحة!”
لكن مهلا، هذه ليست نهاية الرواية بين مراد وهبة، فبقية الصورة كما يرويها الراوي العليم: صفحة 188
" كانت الصورة في حياته جميلة شهية، كمائدة منسقة مليئة بما لذ وطاب، ولكنه عاجز عن التذوق، فيدخل الطعام جميل المنظر الى فمه ويتحول هناك الى تراب! حياته روضة من زهور جميلة، لكنها بلاستيكية لا حياة فيها ولا رائحة لها"
"فكان مراد يعود كلّ يوم إلى منزله، يحرص قبل فتح بابه على لبس الأقنعة ووضع مساحيق التجميل، يرسم ابتسامة وشوقا وحنينا لا يتجاوز أيّها قشرة سميكة تغطي جلده. “
وكان الانفصال عن هبة التي كان الحبّ عندها لا يعدو الأسلوب الخدماتي كالاهتمام بالزوج ورعايته وإنجاب الأطفال، فالحبّ لديها كان متضمنا في مفهوم الزواج العادي!!
في المقابل كان الحنين يشدّه إلى كهف سلمى كما الصدفة التي تشدّه إلى مزرعتها، والجدير بالذكر هنا أنّ الحبّ والأمان في هذه الرواية ارتبطا بالمكان، وليس أي مكان، إنّما تلك الرقعة المتعلقة بسلمى الحبّ الأول والصادق، فكهف سلمى كان مكانا خلق فيه الحب ونما واحتُضِن أيضا، ليقمع في بيت أهل مراد على يد أمه، وفي الجامعة بكلّ الأشكال، حيث حلّ التباعد التدريجي محل اللقاء اليومي.. وصولا إلى الفراق.. ثم الحبّ الذي يموت في بيت مراد: بينه وبين زوجه، ليعود الحبّ ذاته في مزرعة سلمى ويتجدّد.. وكأنّما للمكان فعلا علاقة وطيدة بالحب كما جاء غاستون باشلار في كتابه "جماليات المكان" بمفهوم المكان الذي حصره في بيت الطفولة بأقسامه.. حيث الراحة والسكينة قديما وحيث الحنين لاحقا، هكذا كانت أماكن سلمي بالنسبة لمراد.
وكان يا مكان! فعند معاودته اللقاء بسلمى وتعدّد اللقاءات بينهما حتى جاء الطوفان! :
" أخبرها أنّه الطوفان آت إليها، ولا سفينة لديها تحميها! هو البركان سيبتلعها ولن تجد من حممه مهربا! هو الإمبراطور الذي سيروض تنينها ويعتليه في رحلاته! هو الغازي الوقح الذي سيعتذر عن الدمار الذي سببه لكنّه سيستمر في حملات دماره! (الرواية: صفحة 223)
كأنّ الحبّ الأوّل قد عاد، وأوّل الحبّ أجمله. حينئذٍ تتحوّل المعشوقة إلى كلّ النساء، ويصبح المعشوق علّة تَجمُّل المرأة ليرغبها بلا هوادة.
لا تخيّب الروائية آمال قرائها في عملها "الضائع" فتقدم رواية رومانسية مدججة بكل التقنيات الفنية إضافة للغة التي تُعد من العناصر الجاذبة للمتابعة، وتقدِّم مضمونا متينا من حكاية حبٍّ تحيلنا تلقائيا إلى رواية الأسطورة ماركيز "الحب في زمن الكوليرا"، مع مراعاة تكاثف الأحداث في الرواية الثانية، حيث ينتصر الحبّ رغم العقبات ومرور السنين، ففيرمينا داثا وكانت صبية ترفع نظرها لترى مَن الذي يمر عبر النافذة، وكانت هذه النظرة العابرة أصل كارثة حبّ لم تنتهِ بعد مرور نصف قرن من الزمان مع شاب اسمه فلورينتينو أريثا، وفي رواية "الضائع" رغم أنّنا لم نرصد مثل هذه الواقعة أو تشابك أحداث الرواية أو زمنها إلا أنّنا ندرك أنّ سلمى ومرادا كانا يتشاركان الحبّ الذي ظلّ متذبذبا منذ أيام المدرسة، مرورا بصدفة اللقاء بعد عشرين عاما، اللقاء الذي توّجه الزواج! فرغم أنّ سلوان تأمر قلب بطلها "مراد" بالفرح والحب على غرار الأغنية الذائعة الصيت لماجدة الرومي ومن قصيدة نزار قباني "أحبّك جدا"، إلا أننا وكما في خاتمة الرواية: نجد أصابعنا تخدرت ونعتقد أننا ارتحنا، و لكننا في الحقيقة نسينا في مرحلة التشكيل من كنا!
من يقرأ "الضائع " لا يعود من الحبّ بخفّي حنين – بل ينتشي بالنهايات السعيدة حيث تعودنا أن تقتل الروايات والمسرحيّات أبطال الغرام لأنّ الأدباء يعرفون أنّ الموت المأساوي أشرف لصورة الحبّ من موت الشعلة الغراميّة اعتياداً أو سأماً، ولأنّ الأدباء يفضّلون الدموع على خيبة الأمل...