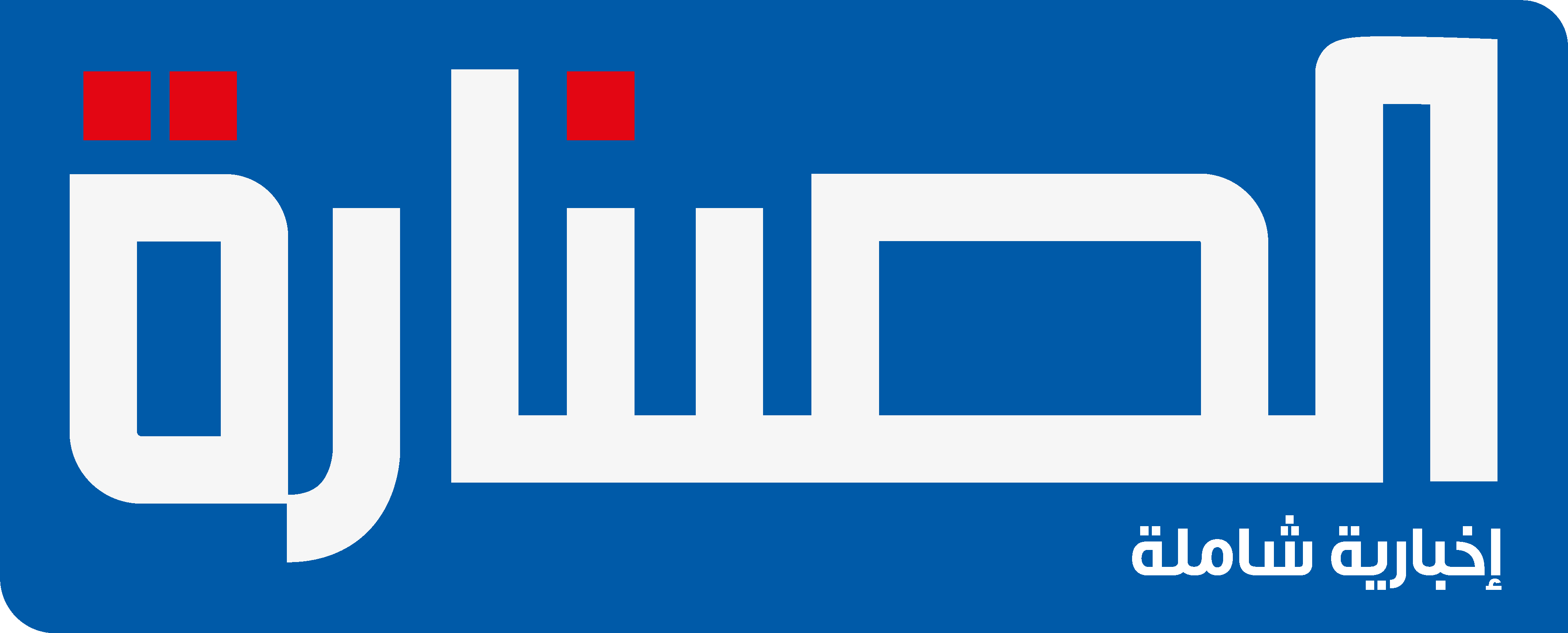الأسطورة والحكاية والواقع في رواية العاشق الذي ابتلعته الرواية لأُسَيْد الحوتري
صنارة نيوز - 01/02/2025 - 6:38 pm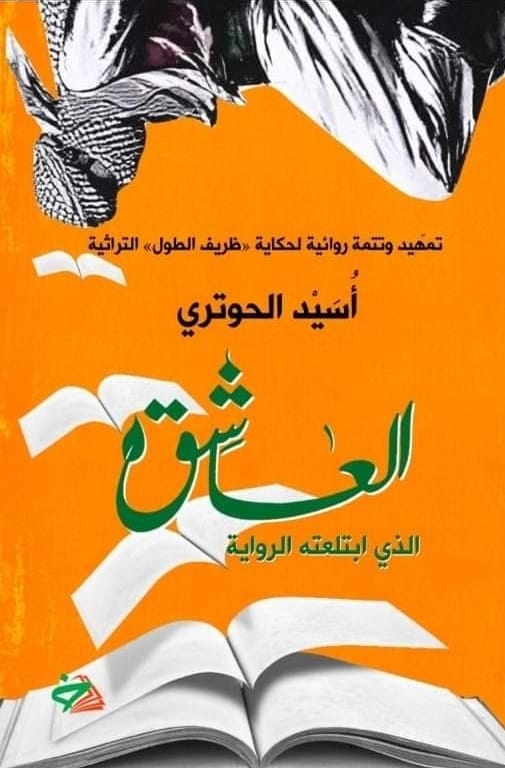
بقلم: الناقد رائد محمد الحواري
من جماليات الأدب الجمع بين عناصر مختلفة: الواقع مقابل الأسطورة والتراث، الرمزية مقابل الواقعية، الحب مقابل الحرب، بحيث يجد كل قارئ شيئا مما يفضله في العمل الأدبي. نجد في "العاشق الذي ابتلعته الرواية" مجموعة من هذه الأضداد، واللافت ليس وجودها فحسب، بل الطريقة الفنية التي استخدمت بها. فالروائي يأخذنا إلى أسطورة بعل وعنات الكنعانية، والصراع مع الإلهين: (يم) و(موت)، ثم إلى حكاية "جبينة راعية الغنم" الشعبية، وكيف أن الخير أو الحق ينتصر على الظلم والباطل في النهاية. يسير السارد بنا إلى حكاية "ظريف الطول" الذي يتماهى مع قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما يلتقي بالشقيقتين: صفاء وهناء. ومع هذا التناص القرآني الذي نُثر بين ثنايا الرواية، نصل إلى جمالية التقديم وإلى إيمان السارد بالنصر المبين.
أما في ما هو متعلق بالواقع، فالأحداث الممتدة تتناول نهاية الحكم العثماني، ودخول الإنجليز إلى فلسطين، وصولا إلى معركة طوفان الأقصى، والمكان ثابت/باقي، وإذا ما علمنا أن هناك مواقف سياسية يتناولها السارد، ومشاهد فانتازية، فمن المُلاحظ أن السارد عمل على وضع "مُخففات" تحد من قسوة الواقع البائس الذي تمر به فلسطين خاصة والمنطقة العربية عامة.
وفيما يخص مسألة التشابك/التداخل، وفنية تقديم أحداث الرواية يقودنا السارد إلى رواية "المتشائل" لإميل حبيبي، ورواية "البحث عن وليد مسعود" لجبرا إبراهيم جبرا، وإذا ما علمنا أن هاتين الروايتين تتحدثان عن شخصيتين مختفيتين "سعيد" و"وليد" وأن الروائي قد أستخدم الجمل التالية: "عناتي، يا عناتي/ لا تمكثي في العالم العلوي أكثر/ فما عدت على السجن أقدر" وعبارة "فقد اختفيت، ولكنني لم أمت."وقد نثرها في فصول الرواية بشكل متكرر، نصل إلى جمالية العرض والسرد الذي يتشكل بربط ماضٍ أسطوري: أسطورة بعل، بواقع اليوم: الفلسطيني المناضل. بمعنى أن هناك نص أسطوري غارق في القدم لكنه ممتد ومتواصل حتى الآن. إنّ فكرة اختفاء بعل وانتظار عودته ما زالت حاضرة في وجداننا السوري/ الفلسطيني، وما انتظارنا للمهدي المنتظر إلا صورة عن هذه العقيدة التي لا تسلّم بالموت ولا بالنهاية، وتؤمن الخير، والنصر، والخصب قادم لا محالة.
البعل، عشتار، عنات:
بداية أشير إلى أن هذه الآلهة ما زالت حاضرة في وجدان السوري رغم وجود الديانات السماوية، ورغم مرور آلاف السنين على اعتناقها، فما زلنا نقول:"أشجار بعلية"، "عشّرت الغنمة"، "عين المية"، وإذا ما علمنا أن هذه الآلهة آلهة ريفية متعلقة بخصب والأرض وما عليها من نباتات، وحيوانات، وبشر، ومتعلقة بدورة الحياة الطبيعية: الشتاء، والربيع، الصيف، والخريف، الموت والحياة، نصل إلى "أبدية" هذه الحياة التي لا تنتهي ولا تزول، فكل "نكسة/موت" يتبعه "خصب/حياة" وكل غياب يلحقه حضور. هذه عقيدة السوري منذ أن وُجد على هذه الأرض.
إن توظيف هذه العقيدة، أو الفكرة، أو الأسطورة في نص أدبي روائي حديث يؤكد استمرارها، واستمرار بقاء السوري على حاله متجذرا في أرضه. يربط السارد هذه الآلهة بأحداث الرواية من خلال أسماء الشخصيات: "وعندما وضعت عشتار صغيرها الذي اسمته عليان، ذاع صيت الأسرة في كل الجليل، لأن عليان كان أجمل أطفال فلسطين قاطبة، عندما كان عليان صغيرا عرف ب"علي" ولما بلغ الحلم، وأصبح فارع الطول، عريض المنكبين، مفتول العضلات، أطلق عليه أهل القرية لقب "ظريف الطول"...كان ظريف الطول مولعا بالأرض والشجر" (40-41)، نلاحظ أن السارد يجمع الأسطوري: عليان بعل، بالقديم: علي، بالحاضر: ظريف الطول، مشيرا إلى ارتباطه بالمكان وبالأرض: "الجليل" و"فلسطين". كما نلاحظ أن الأسماء الثلاثة "عليان، علي، ظريف الطول" كلها تخدم فكرة الاستمرار، والبقاء، والحضور من جهة، وفكرة القوة، والتميز من جهة أخرى، وهذا يخدم فكرة البطل الوسيم، والقوي، والخالد، الذي ويسحر المتلقي بحضوره.
بعل راكب السحب
من صفات الإله عليان بعل، أنه راكب السحب، ومرسل الصواعق، ومنزل المطر، وهذا ما أكده السارد في الرواية: "اختارت عنات تصميما على شكل سحابة، طبع في نفسها صورة الإله عليان بعل (راكب عربت) وهو يركب غمامه الفضي، ويضرب المزن بسوطه فينهمر الغيث على الأرض وفي عيون الماء" (54). نلاحظ علاقة بعل بالأرض، فكل أفعاله متعلقة بها، بمعنى أنه مقترن/ مرتبط بالأرض، ولا مكان له خارجها، وهذا يقودنا إلى تجذر سوري بالأرض والمكان.
(ينقل) لنا السارد فكرة مولد بعل، وما يجلبه من خير على الأرض: "في السماوات العلى حيث ولد الإله الصغير الذي في المهد، كان، وكان عند رأسه أبو (دجن) إله الخصب والحصاد، وأمه (شالاش)، وعند قدميه انتصب جده (إيل) رب الأرباب، وجدته (إيلات)، ومن حولهم تحلقت كل الآلهة بجلال وجمال. من المعابد خرج الكهنة تحت المطر يركضون، يهتفون، يبشرون العالمين بميلاد رب البيت، السيد، المالك، الملك، إله الخصب والأجواء والعواصف والبرق والمطر، إله الطقس، ساقي الحرث والنسل، يبشرون بمولد عليان بعل" (82-83). نلاحظ أن السارد يتحدث عن مولود سماوي لكنه متعلق بالأرض، وهذا يقودنا إلى علاقة السماء بالأرض، بمعنى أن السماء وجدت لخير الأرض ومن عليها، من هنا وجدنا الكهنة يركضون فرحين مبتهجين، وهذا الأمر يحسب للسوري الذي يؤمن بأن العلاقة بين السماء والأرض علاقة تكاملية، وليست منفصلة، فالخير يأتي من السماء لخدمة الأرض ومن عليها، والأرض وأهلها يعظمون السماء لخيرها وعطائها.
وهذا ما أكده مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة عندما تحدث عن العلاقة السليمة بين السماء والأرض قائلا: "اقتتالنا على السماء أفقدنا الأرض"، فالخلل في فهم علاقة السماء بالأرض يؤدي إلى التهلكة والفناء. من هنا جاءت أسطورة بعل لتؤكد العلاقة الوثقى بين السماء والأرض.
ما بين الحضور/الحياة والغياب/الموت
أن العقيدة الدينية السورية القديمة متربطة بدورة الطبيعة وخصوصا الربيع والخريف، بالحياة والموت، ومن هنا جاءت فكرة الغياب المؤقت، فكل حياة يتبعها وموت وكل موت يتبعه حياة، هذه الفكرة ما زلنا مؤمنين بها، وهذا ما نجده في أغانينا الشعبية:
"على دلعونا وعلى دلعونا/ راحوا الحبايب ما ودعونا/ من باب البروة لكفر كَنّا/ ما زالك عزب لظل استنى/ سخنا المي وعجنا الحنا/ كله عشانك يا أم العيونا" (64)، في هذا المقطع نجد فكرة الغياب والحضور، "راحوا الحبايب/ لظل أستنى"، وفكرة الخصب وطقوس الزواج المقدس، "سخنا المي وعجنا الحنا"، وبقاء المكان "البروة، لكفر كنّا" كعنصر أساسي وحيوي في الأحداث، من هنا كانت أغنية: "يا ظريف الطول وقف تاقلك/ رايح عالغربة وبلادك أحسنلك" (63)، كتأكيد أن المكان فاعل وحاضر ولا يمكن للسوري أن يكون خارج مكانه وأرضه.
صراع الحياة والموت
نجد في الطبيعة ربيع وخريف، مطر وجفاف، خصب وقحط، وهذا انعكس على عقيدة السوري الذي رأى أن هذه الاختلافات حالة طبيعية/عادية ويجب التعامل معها بنظرة طبيعية/عادية، وهذا ما أكده القرآن الكريم (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا)، [الشرح:5]ٍ لذلك يجب القبول أو التعايش مع الرخاء والشدة، لأنه أمر طبيعي عادي.
ينقل السارد الصراع بين بعل وأعدائه كما جاء في الأسطورة: "وصلت الرسالة، قَبِلَ (يم) المبارزة، تم تحديد الموعد، وجمعت الآلهة ضحى، وصل بعل برفقة إله مختص في التصنيع العسكري يدعي (كوثر وحسيس) عندما ظهر (يم) من أعماق البحر عملاقا تتصبب منه المياه، جبارا تقشعر لرؤيته الأبدان، أطلق على بعل أمواجه البحرية، فسحبته وكادت أن تغرقه، لكن بعلا وفي اللحظة الأخيرة كسحها بسوطه الرعدي، وفر بغيومه إلى السماء، لحق به (كوثر وحسيس) وسلمه سلاحا أسمه (العاصف)، كان قد ردد عليه تعويذة تمكنه من اختراق كتفي (يم). قذف بعل بـ(العاصف) فأصاب (يم) بين كتفيه، فعصفت به الآلام والأوجاع... هانذا بمثابة الميت، إن بعلا هو الملك حتما، لقد فتح بعل المياه الجامحة وأصبح إله كل الأرض" (87-88)، وهذا ما يجعل فكرة الصراع فكرة عادية ولا تستوجب الغم والحزن، لأنه سيتبعها الخير بالتأكيد، وما انتصار بعل إلا صورة عن هذا الخير القادم.
الغياب في "المتشائل"، و"البحث عن وليد مسعود"
يستخدم السارد غياب سعيد في رواية "المتشائل"، وغياب وليد في رواية "البحث عن وليد مسعود"، لما له من علاقة بفكرة الرواية. الغياب لا يعني الموت بالضرورة، ومن هنا جاءت هذه الفقرة "فقد اختفيت، ولكنني لم أمت." في أكثر من موضع في الرواية، وهذا منسجم مع فكرة غياب بعل الذي سيعود بالتأكيد حاملا معه الخير والخصب والفرح، سيعود بعل رفقة مسعود وسعيد ليساهم كل الغائبين في نهوض فلسطين رغم الغياب.
التداخل بين الواقع والأسطورة
اللافت في الرواية الجمع بين الواقع والتناص الأسطوري. هذا المزج يحتاج إلى فنية استثنائية لتمرير وإقناع المتلقي بهذا التقديم، وأعتقد أن السارد نجح في هذا الأمر من خلال وجود رابط يتمثل في قصة "ظريف الطول" والأغاني الشعبية المتعلقة به. يحدثنا "ظريف الطول" عن هذا المزج قائلا: "تقتلني الوحدة والعزلة، رغم أني لست وحدي، فمعي "أناواتي" فأنا أكرم، وظريف الطول، وعلي، وأنا الآن السجين رقم (181) الذي حمل رقم زنزانته بعد أن فقد إنسانيته" (75). حلول الشخصيات في بعضها يشير إلى أننا أمام شخصية "زئبقية" لا يمكن تحديدها، فهي تحضر بأكثر من هيئة، وأكثر من شخص، من هنا عندما تناول السارد حالة بعل وصراعه مع (يم) أعاد المتلقي إلى "ظريف الطول" السجين الذي كان يردد: "عناني، يا عناتي/ لا تمكثي في العالم العلوي أكثر/ فما عدت على السجان أقدر" (89)، وإذا علمنا أن هذا النداء تكرّر بكثرة في الرواية تارة على لسان الإله عليان بعل وتارة على لسان ظريف الطول، عرفنا كيف استطاع السارد الجمع بين الواقع والحكاية الشعبية والأسطورة.
نجد هذا التداخل في ما قالته عنات: "أنا وظريف الطول كنا القضية، كنا الإنسان، وأرض كنعان هي المكان، وقصة الحب هذه أزهرت مع بدايات الزمان، قصة خالدة، يتجلى بطلاها الخارقان في أبطال بشرية من أرض كنعان، ينشران الخير والخصب والسلام والأمن والأمان، ويتعاركان مع الشر والطغيان، من سيصدق ما عشته مع ظريف الطول عندما تلاقينا في عين الماء، عندما توقف الزمن، وعاد بنا إلى أسطورة الإلهين عليان البعل والعذراء عنات لنحيا كل تفاصيلها معا؟" (119). نلاحظ هنا السلاسة في حديثها، فهي تؤكد فكرة حلول الشخصيات في بعضها، وهي مسألة "عادية طبيعية"، فما الحب الذي نشأ بينها وبين "ظريف الطول/علي/عليان" إلا استنساخا وتكرارا لما جرى بين الإلهين بعل وعنات، وها هو يتكرر من جديد، فما الغريب في هذا الأمر؟
هكذا كانت "العاشق الذي ابتلعته الرواية" خيطا ناظما لأسطورة الإله بعل الكنعانية، ولحكاية ظريف الطول الشعبية الفلسطينية، وللواقع الفلسطيني المقاوم حتى هذه الساعة.